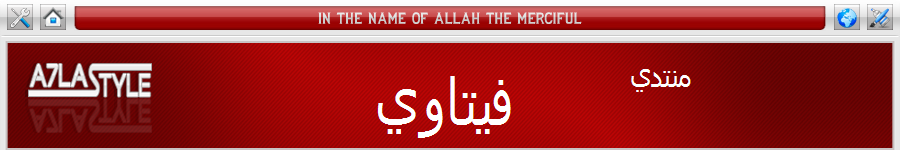الدكتور عادل عامر
لما انطلقت الصحوة الإسلامية في بداية القرن الماضي كانت الأمة تعيش تمزقًا حضاريًّا رهيبًا، ساهم فيه الداخل والخارج على السواء. كانت القابلية للانهزام والتبعية والتقوقع، حالة حملتها الأمة في ثقافة الاستبداد السياسي والفقر الاقتصادي والجدب العلمي والمعرفي، في واقع مهتز على أكثر من باب، يصفه أحمد أمين في شكل مزعج: "فساد نظام واستبداد حكام وفوضى أحكام وخمود عام"[[1]]. فكانت الصحوة تعبيرًا عن عمق الأزمة ومحاولة وطنية وإنسانية لتجاوزها، مثلتها في بعدها السياسي والشمولي الحركة الإسلامية الحديثة. وبعد مرور قرن من الزمن وما طاف بهذه الأخيرة من تحديات، وما شابها من إخفاقات ومراجعات، وما عاشتها من نجاحات وتمكين.. فإن إطارًا جديدًا للحالة الإسلامية بدأ يطرح نفسه منذ عقد من الزمن، تمثل في ظاهرة التدين الاجتماعي، أو الإسلام القاعدي والفطري، بعيدًا عن الركب السياسي. كانت عودة روحية أخلاقية، مثلت في الغالب رد فعل تجاه واقع مادي متعاظم، ومحاولة للنجاة الفردية أمام صعوبة النجاة الجماعية التي حملت صيغتها الحركة الإسلامية، وتأكيدًا للدور الأساسي للأمة في أي مسار للتغيير. وفي تصفح أطوار هذه الظاهرة تبدو عفويتها وفطريتها أساسًا لنجاحها؛ حيث بدأت في الانتشار بسرعة كبيرة عمّت الأفراد والمجموعات والمؤسسات، لا يحدها انتماء سياسي أو وظيفي أو طبقي، ولا يحدد إطارها فرد أو جماعة أو مؤسسة. غير أن أسئلة عديدة بدأت تطرح نفسها في خضم هذا المشوار وهذا الإطار الجديد للصحوة، في علاقة هذه اليقظة مع الحركة الإسلامية، هل هي نهاية صيغة وطرف وتمثيل؟ وماذا بقي من أطروحة التغيير للحركة الإسلامية المعاصرة؟ هل يعني حديثنا هذا غفلة عنها وخبوتا للإسلام السياسي، وانتهاء لدوره الريادي في التغيير؟ هل توخِّي منهجية التدين الاجتماعي تعني فشل منهجية التمكين السلطاني، وانهيار أولوية الدولة على المجتمع؟ وبالتالي يمثل الإسلام السياسي محطة خاطئة في مسار التغيير؟ أم أن أدوارًا أخرى تنتظره ومحطات جديدة تناسبه، لتجعله أكثر تأهيلا لقيادة عملية إصلاح مجتمعه إذا وعى مهمته وكنه دوره واستوعب واقعه؟ لتكون منهجية التدين في لقائها مع الإسلام السياسي الحلقة المفقودة وهمزة الوصل المنشودة لنجاح المسار التغييري للمجتمع، وتأكيد الدور المنسي أو المغيّب للأمة. المفارقة الكبرى: شمولية الطرح وحزبية الممارسة في مراجعتنا لمسار الحركة الإسلامية يطالعنا تأرجحها بين الطائفية عند تنزيل مشروعها في تبنيها لمبدأ التحزب، والشمولية في التنظير التي كثيرًا ما أدت إلى تبوئها مقام المتحدث الرسمي والوحيد باسم الإسلام، واعتبار فهم الجماعة هو الفهم، وأن اجتهادها هو الاجتهاد، حتى يصبح الولاء للجماعة ولاء للدين، وأن خلافها -في غالبه- خلاف ميوعة أو نفاق أو زندقة، إن لم يكن خلاف تكفير!. هذه الطائفية عند تنزيل المشروع تمثل نتيجة طبيعية لمفهوم السياسة القائمة على تبني مفاهيم معينة للتمكين والتسيير، يجتمع عليها أفراد ليكونوا مجموعة صاحبة مشروع وبرنامج للحكم. وتلتقي مع هذه الأطروحات أطراف وتخالفها أخرى، وهي مسلمات التعامل الديمقراطي والتعدد الحزبي. فالإشكال ليس في تجنب الخطاب الطائفي والحزبي عند التنزيل؛ لأن هذا هو منطق التحزب والتناظر والنزال الديمقراطي، لكن المفارقة كيف تبني مشروعًا شموليًّا يجمع شئون الدين والدنيا بأداة حزبية ولسان فرقي وإطار تعددي؟ وهذا يمثل -حسب ظني- التناقض الذي حملته الحركة الإسلامية الحديثة بين أحشائها منذ ولادتها. كان جواب مؤسسها الأول حسن البنا صريحًا في هذا الباب حتى يتجنب هذا الوضع، أن الحزبية السياسية بغيضة، وأن الأحزاب مصنوعة وليست حقيقية ولا تجوز في ديار الإسلام[[2]]، وأن الحركة الإسلامية هي أكبر من حزب سياسي، وأن الإخوان جماعة فوق الأحزاب جميعها[[3]]. فكان رفض التحزب وعلو المشروع مخرجًا لتفادي هذا الإشكال. غير أن العيب الأكبر والمطب الأخطر لهذا الطرح هو السقوط في الشمولية عند التنزيل، واحتكار الصفة الإسلامية، ومجانبة حالة التعدد والديمقراطية داخل البلاد، ولعله الاقتراب في نهايته من ثيوقراطية مخيفة وأحادية مستبدة. ورأى فريق آخر -وعلى نقيض الطرح السابق- رفض تحزب الإسلام أو الحركة الإسلامية، في مقابل السماح بالتحزب لأطرافها، وكان من أبرزهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي عبّر عن استيائه من زيغ الحركة الإسلامية عن الدعوة والإرشاد وانجرافها في المستنقع السياسي وما يجره من فتنة ومنازلة، وانهيار لقدسية الدين وطهره، وما يتطلبه كذلك من تكتل ومنافسة وندّية للآخرين؛ فتفقد الحركة هذا القاسم المشترك، وتنعزل وتسقط حيث يجب الاختلاط والنهوض[[4]]. إن النقد الموجه لهذه الأطروحة يدور غالبًا حول خطورة استبعاد الدين من المعترك السياسي، والفصل انتهاء بين الدين والسياسة، وهو ما وصل إليه بعضهم لما دفع هذا التعليل إلى منتهاه، كما ينذر هذا الطرح بالرجوع إلى حالة الغيبة السياسية للإسلام التي سبقت ظهور الحركة الإسلامية الحديثة، والتي مثّل ظهورها ملئًا لهذا الفراغ واسترجاعًا لدور مفقود. إن اللافت للنظر أن كلتا الأطروحتين تجتمع على الدور المنشود للجماهير وللأمة، وأن نجاح التغيير يتم إما عن طريق تجميع الأمة تحت غطاء الحركة الإسلامية "السياسية"، وهي اجتهادات حسن البنا وجماعة "الإخوان المسلمون"، أو عبر حفظ هذه الجماهير في نطاق واحد بعيدًا عن الإسلام السياسي الذي لا مبرر لوجوده؛ لأنه أصبح عنصر تشتيت وتفريق للأمة، وهي افتراضات الطرف المقابل. من خلال هذا الاعتبار للأمة يتجلى لنا المدخل الأساسي لما نطرحه. فالمشروع السياسي كان يفتقد -ولا شك- إلى هذا المرتع الخصب وإلى هذه الملاءة الشعبية التي يمثل رجوع الجماهير إلى رحاب الدين ينبوعها وصمام أمانها، وذلك عبر ما تثمره منهجية التدين من نتائج وتحولات؛ فقد تُغيّر النفوس وتُشبعها عبادة وسموًّا أخلاقيًّا وروحيًّا، وهي محطة أساسية وأولية في مسار التغيير كما عنيناه في مقال سابق[[5]]، ليصبح الإسلام السياسي المحطة الأخيرة فيه. ففي هذا الإطار وعلى خلاف أصحاب الطرح الأول، لن يتحمل الإسلام السياسي مهمة التغيير النفسي كما يبدو لهم، ولكن يتركه لحالة التدين الاجتماعي، ولن يمثل بالتالي كل حلقات التغيير. وفي مقابل أصحاب الرؤية الثانية لا تنسحب الحركة الإسلامية عن الركح ولا تضمحل كما يرون، ولكن تظل تؤدي وظيفتها حزبيا وسياسيا، مع اختلاف تدخلها في المسار التغييري. إن إمكانية وصول الحركة الإسلامية إلى التمكين لا يزال صعب المنال في ظل الخارج الرافض والداخل المرتاب أو المناهض؛ نظرًا لحملها لمشروع نقيض ومغاير للمطروح، يصعب تبنيه ومساندته دون محطات تقشف ومراحل تنزيل صعبة ومكلفة للبلاد والعباد، والتي يمكن أن تتعدى الجيل والجيلين؛ لذا فإن حمل هذا المشروع لن يكون طائفيًّا تجتمع عليه فئة فحسب، بل وجب أن يكون حامله هو نفسه المنزّل عليه، حتى يتبناه ويعيش على إنجاحه طوعًا دون إكراه، ويرتضي فترات التقشف المضني والزهد، التي تتطلب جهدًا وصبرًا ومثابرة، ولعلها تكون الغالبة، خاصة في بداية التمكين والتحدي، وليس نرى غير الأمة في امتدادها القادرة على ذلك. فمشروع الحركة الإسلامية هو مشروع تبنٍّ أكثر منه مشروع انتماء، يتجاوز الإطار الآني ليجمع الدنيا والآخرة؛ فتتعدى نتائجه والمكافئة المرجوة منه البعد المادي البحت، فمن لا أجر له هنا له كل الأجر هناك. قد تتراوح أشكال التغيير وأصنافه ومنهجياته بين تربية النفس وتهذيبها، وتشكيل العقول وتوعيتها، وتنظيم الاقتصاد وتخليقه، وتبديل الحكم وآلياته. وهي محطات لا نخال أن للإسلام السياسي دورًا مجديًا في اجتماعها تحت مظلته في كل المراحل، وإلا وقع في منازلة ومواجهة مع أطراف المجتمع، سلطة ومعارضة وحتى جمهورًا. وهو ما أسفر عن سلسلة من المواجهات بينها وبين السلطة والمجتمع المدني والجماهير العربية: فقد صار الصراع مع السلطة صراعًا للأقطاب ونزالا حتى الموت لخلوص السلطات القائمة في استنتاجاتها إلى أن المواجهة غير مضمونة العواقب بدون استعمال العضلات؛ لأن الإسلام السياسي قد جمع كل حلقات الفضاء الإنساني، وخاصة الجانب النفسي والثقافي والشعوري والوجداني، معتمدًا في ذلك على هوية الجماهير وموروثها ومرجعيتها، التي لم يتزعزع بنيانها الإسلامي رغم الهزات والضربات من الداخل والخارج. وصارت المواجهة مع أحزاب المجتمع المدني الذين خلصوا أيضًا إلى أن المنازلة مع الإسلام السياسي لا يملكون كل أوراقها، وأنها قضية مهزومة لا محالة. وما النداء باستبعاد الدين عن السياسة إلا محاولة سياسية من هؤلاء لهدم هذا الرباط بين الإسلام السياسي والإسلام المدني حتى تفقد الحركة الإسلامية إطارها وزخمها وفعاليتها. وبلغت في بعض الأحيان كونها مواجهة مع الجمهور نفسه عندما ينال البعض منهم، تحت تأثير ظروف وحالات ووقائع داخلية أو خارجية، الخوف والريبة من أن يتضخم الإسلام السياسي فيأكل الحابل والنابل وينفرد بالساحة حيث لا رقيب ولا مراجع، فيصبح النقد عداء والمراجعة كفرًا بواحًا. إن مهمة الإسلام السياسي في ظل هذا المنهج التديني العام والصاعد تتنزل في مرحلتين:
1. مرحلة أولى تتمثل في عدم اقترابه من هذا الزخم وهذه الاستفاقة الدينية خطابًا ورجالا. فلليقظة رجالها وخطابها ومنهجيتها وإطارها، وللحركة الإسلامية خطباؤها ومشرفوها وميدانها، بعيدًا عن المسجد ودور التدين العام ومناسباته، حتى لا يصطبغ هذا بذاك، وتختلط الأطر ويفقد كل منهما خصائصه ودعائم نجاحه.
2. أما في المرحلة الثانية فإن هذا المد التديّني الذي انطلق شعيرة وطقوسًا سوف يبحث عن البديل في مجالات أخرى؛ فلن تقتصر عبادته لربه في تسبيحات وأذكار وريادة مسجد وصيام وعمرة فقط، بل تتجاوزه إلى مجالات التعامل السياسي والاقتصادي والأحوال الشخصية والقانونية وقضايا الحكم والإدارة، فالصلاة عادة والصوم جلادة أما الدين فهو المعاملة، ولن يكون المدد سوى من الإسلام السياسي. إن المرحلة الأولى، مرحلة الانتظار ليست غيبة ولا انسحابًا عن الساحة، لكنه حضور دون ظهور، وهو الابتعاد عن الأضواء الكاشفة بلغة الإعلاميين، وهي محطة حساسة وهامة لإنجاح المشروع الحضاري العادل في المجتمع والدولة، ويتطلب الكثير من الصبر والمثابرة أمام إغراءات الواقع وإثاراته ونداءات الأنا وأحلامه، نحو لعب الأدوار الأولى والوصول السريع إلى كراسي الحكم، ويدعو كذلك إلى التريث أمام استفزازات الأطراف المقابلة. لقد قاست الحركة الإسلامية في عمومها من الضرب المتواصل لهذه العلاقة الخاصة والمباشرة التي جمعتها بالجماهير، ووقع السعي الحثيث لاستبعادها من كل الميادين والأطر التي تقترب منها، وهو ما عُرف في بعض البلاد بسياسة تجفيف الينابيع. فأُغلِقت دور الثقافة والعلم والتربية والعبادة في وجهها وحيل بينها وبين الناس. فنتجت عنه مواقف متباينة من الجماهير: فريق فضل السلامة ووقف على الأعراف ينتظر، غير أن تباعد المدة جعله يفقد الأمل وينحاز نهاية إلى المعسكر المنتصر. وفريق ما زال على العهد يؤمن بالفكرة، ويؤيد المشروع، ويناضل بما يتاح له لاستمراره ونجاحه. وفريق ترك المشروع السياسي، ولكنه لم يترك الهم الإسلامي، وفضل النجاة الفردية على الموت الجماعي. وفريق خابت آماله في المشروع بعدما هاله ما وصل إليه في بقاع أخرى بلغت مرحلة التمكين ولم يحصل التغيير والرفاه المنتظر، واقتنع بعد حملات إعلامية رهيبة قامت بها أطراف في الداخل والخارج بأن مشروع الحركة الإسلامية ليس المهدي المنتظر، بل لعله كابوس آخر الليل!. وفريق مغلوب على أمره، يلعن السياسة والسياسيين، فضل الابتعاد والانسحاب والاعتكاف على البحث عن لقمة العيش، والعمل على الارتقاء اجتماعيًّا واقتصاديًّا بعيدًا عن السياسة ومشاغلها. وفريق معاند معاكس ومعادٍ للأطروحة وأهلها جملة وتفصيلا: قناعة فكر وأيديولوجيا، أو قناعة مصالح ومراكز. قطعة الفسيفساء هذه مثّلت العنصر الهام في معادلة العمل الصائب والنجاح في إحداث التغيير في المجتمع؛ فبغياب الجماهير وعدم التفافها وتبنيها للمشروع، تفقد أي أطروحة مصداقيتها وشروط فلاحها، وإذا غابت الأمة غاب الحامل والمحمول، وانهار المشروع، وهذا ما يكاد يحصل الآن للحركة الإسلامية باستبعاد السند والمدد عنها، رغم صفاء الينبوع وصلاح الرؤى وإخلاص العاملين، ورغم هذه اليقظة المتعاظمة للإسلام الفطري. لقد مثلت منهجية "خلوا ما بيني وبين الناس" التي أطلقها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أساس نجاح الدعوة الإسلامية الأولى، والمبنية على الثقة في النفس وفي صلاح المشروع ورشاده وعلى تجميع الأمة حوله. غير أن هذه المنهجية تبدو الآن مستبعدة ومفقودة. فالحركة الإسلامية حيل بينها وبين الناس، ومُنعت سُبل اللقاء والتواصل، وليس لها سوى الاضمحلال أو طَرق باب المجهول، والدخول في مواجهات عقيمة ومتاهات ميئوسة. والبديل المطروح لهذه المنهجية الساعية إلى الناس والمعدومة حاليًا هو ترك الناس يسعون إلى المشروع عبر مسارهم التديني الصاعد، بعد أن تكتمل قابلية الأمة على حمل المشروع وتبنّيه في بعده الشامل؛ ليصبح شعارها بعد حين من "خلوا ما بيني وبين الإسلام" في مرحلة التدين الحالية التي حملتها الأمة، إلى "خلوا ما بيني وبين المشروع الإصلاحي العادل"، الذي تحمله الحركة الإسلامية في كل مراحل ومحطات تواجدها. أين الخلـل؟ إن مرحلة الانتظار الفاعل والذكي تستند إلى مجموعة مبادئ وفرضيات، وقع طمسها غالبًا عند ممارسة الحركة الإسلامية لنشاطها لأسباب عديدة ساهم الداخل والخارج في تعميقها، رغم تواجد بعضها في أدبياتها وفي مراجعاتها وتقييماتها، منها التدرج السليم وعدم إغفال المصالح المشتركة، والرضى بالمسموح به، والتواضع في المطالب، وتفهم الإطار الداخلي والموضوعي والعلاقات الدولية في عمومها. فالتدرج مبدأ قرآني وسنة نبوية وممارسة حضارية، قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر: يا أبت مالك لا تنفذ في الأمور، فوالله لا أبالي في الحق لو غليت بي وبك القدور. قال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله تعالى ذمّ الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق حملة فيدفعوه وتكون فتنة[[6]]. والانتظار شكل فاعل ومدني للتدرج وهو يمثل محطة تتلوها محطات. ولعلّ الحركة الإسلامية في عمومها قد أضاعت في بعض تاريخها لقاءات جادة ومجدية مع حكامها نتيجة نقص تجربة بعضها، أو قلة وعي أصحابها، أو حبًّا في الاستفراد والغلبة بالضربة القضية، أو شعورًا بالعظمة واستنقاصًا لما حولها من سلطة ومعارضة، فنتج عنه جهل وتجاهل لعديد المصالح المشتركة التي غابت في ثنايا الفعل المتوتر ورد الفعل، وخسرت الحركة الإسلامية مواعيد حاسمة مع التاريخ. كان دستور المدينة الذي وضعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محاولة جادة في بناء الجبهة الداخلية رغم تنوعها، ومصالح مشتركة وقع تأكيدها رغم عدم تناغم بعض أطرافها. وكان صلح الحديبية تعبيرًا ذكيًّا عن الهم السلمي للمشروع، ومسايرة لتطور العقلية المقابلة نحو المصلحة المتبادلة، يقول فيه عليه الصلاة السلام: "لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتها إياها" (رواه أحمد). كما كانت بعض تصرفات الحركة الإسلامية في بعض مواقفها غير قابلة للحيز من الحريات أو من الفعل الذي سُمح لها به في بعض الأطر والمجالات رغم قلته ورغم ضيقه في أكثر الأحيان. وكان الأجدى الرضا بالمسموح والعمل على إتقانه واستغلاله واستثماره، سواء كان هذا الفعل يتنزل في إطار دعوة بسيطة، أو تلقين الأطفال في كتاتيب قرآنية، أو تعليم الناس فقه حياتهم العبادية، أو تخليق بعض الممارسات الاجتماعية، أو حتى التواجد في منظمة كشفية، في انتظار الأفضل[[7]]. كما غلب على بعض المطالب التي عبرت عنها بعض الحركات الإسلامية تجاوزها للمقبول وحتى المعقول، ورُفعت السقوف في بعض الفترات مما جعلها في بعض الأحيان تعجيزية، من باب "كل شيء أو لا شيء". وقد ساعدت بعض الفترات الخصبة لحركات إسلامية معينة؛ نتيجة اعتقادها بالتفاف المد الجماهيري حولها.. في عدم تواضعها، ووقوعها في خطأ القفز على الواقع، ونسيان حقيقة حجمها، واستنقاص حجم منافسيها؛ فبنت مطالبها على ركائز خاطئة، ورفعت سقوفها، ورفضت التنازل عنها، وجعلت من نفسها الوصي على المجتمع، فوقع المحظور، وخسرت الحركة كل شيء[[8]]. ولكَمْ كانت الشعارات المرفوعة من مثل "الإسلام هو الحل" تخفي في بعضها ضآلة الأطروحة وتهافتها وغيابها، أو عدم واقعيتها وعدم نضجها. وحتى التي أريد لها أن تنضج كانت المواجهات المستمرة مع السلطات القائمة لها بالمرصاد؛ لوأدها في المهد، وتحطيم ما بدأ بنيانه، فتُعتَقل العقول، وتغيب الأفكار من جديد، وينحسر البناء أو يكاد، حتى يأتي جيل آخر لتكرار المأساة مرة أخرى، وهكذا دواليك، وكأن قدر العمل الفكري لبناء المشروع هو الغياب أو التهميش. الانتظار كمرحلة حاسمة في التغيير إن المنهجية المطروحة للحركة الإسلامية في هذه المحطة في مسارها نحو الحكم.. هي اللاحكم، في انتظار أن يتكفل ولعلّ المجتمع بإسلاميته وتدينه الفردي ثم الجماعي وتسود قابليته، بعيدًا عن وصاية طرف أو كفالته. تواجد الإسلام السياسي في المعارضة غير المعترف بها مثّل دائمًا عند أصحابه عقبة كؤودا يصعب في الأغلب تجاوزها، وشكل استضعافًا مؤثرًا في مردوده، وساهم في استنقاص دوره، وكانت حاجزًا لإشعاعه. وهو ما سعت إليه الأطراف المقابلة، محاولة تهميش فعاليته واستبعاد تأثيراته. فأصبحت هذه الحالة سلبية مؤرقة، حاولت الحركة الإسلامية غالبًا دون جدوى تجاوزها بالحصول على الإذن القانوني لعملها لمن رفض تواجده، أو برفع سقوف ممارستها المسموح بها لمن اعتُرِفَ له بحق التواجد. ولا يختلف واقع الحركة الإسلامية عمومًا، خارج ديارها في المنفى، أو في داخل أوطانها، عن حالة ترقب سلبي يتمثل إما في مواجهة مباشرة وغير رشيدة مع الأنظمة القائمة والتي أدى أغلبها إلى معاناة متواصلة، وإما إلى تضميد جراح سابقة، وإما إلى محاولة تواجد سياسي وحقوقي معلن، وقع رفضه جملة وتفصيلا، في ظل غياب الدعم الجماهيري، تفهمًا أو مناصرة، خوفًا أو رفضًا وعداوة، وهو السند الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي تحول أو تغيير. فمهما تعددت أنماط الشرعية أو اللاشرعية للحركة الإسلامية، فإنها لا تخرج عن أحوال ثلاثة:
1 - تواجد ذي سقف عملي محدد، دافعه الاستقرار للدولة والمجتمع، مع خطوط حمراء لا تُتجاوز، حتى تكون الحركة موجودة للتحكيم ولا للحكم، مثل الأردن والمغرب.
2 - التواجد المتوتر والمرفوض، ولكن بصيغة "قانونية وحضارية" مثل تركيا ومصر.
3 - المواجهة القاصمة والعاصفة في المدر والحضر مثل الجزائر.
فما نطرحه يجعل هذه الحالة السلبية التي تعيشها الحركة الإسلامية حالة إيجابية للمشروع؛ حيث يصبح التواجد على الأطراف صيغة مثلى للتواجد الأدنى والنشاط الذكي، الذي يشكل حالة التواجد والانتظار في نفس الوقت، وهو ليس انسحابًا للسياسي ولا تخليًّا عن المشروع، بل تدعيمًا مستقبليًّا له وحضورًا أكبر في غده.
كاتب وباحث سياسي وقانوني
و عضو مؤسس بحزب الجبهة الديمقراطية